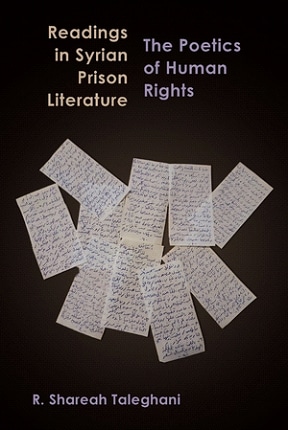
اسم الكتاب: Readings in Syrian Prison Literature: The Poetics of Human Rights
المؤلف: R. Shareah Taleghani
اللغة: الإنكليزية
الناشر: Syracuse University Press
تاريخ النشر: حزيران/ يونيو 2021
عدد الصفحات: 296
الرقم الدولي المعياري للكتاب (ISBN-10): 0815637063
الرقم الدولي المعياري للكتاب (ISBN-13): 978-0815637066
مقدّمة
مما لا شكّ فيه أن تجارب السجناء والمعتقلين السياسيين، ولا سيّما في ظل الأنظمة العربية الاستبدادية، هي مؤشر تُختبر من خلاله صدقية حقوق الإنسان المطروحة كأداة شرعية وعالمية ملزِمة لصون حق الإنسان والأفراد كلّما كان هؤلاء “في حاجة للحماية في مواجهة السيادة الجديدة للدولة، وفي مواجهة الاستبداد الجديد للمجتمع”. وبغضّ النظر عن قصور خطاب حقوق الإنسان ومتبنّيه من دول ومؤسسات وجمعيات وناشطين وتقصيرهم عن إنفاذ بنود الحقوق وتطبيق موادها، والظروف المسبّبة في توهين التأثيرات المرتجاة من دعاوى حقوق الإنسان وإخفاقها(وهو موضوع سنقوم بمناقشته)، فإنّ شريعة طالقاني تعيد إلى الواجهة تجربة الاعتقال والسجن والتعذيب من بوابة الأدب، حيث تنتشل الرواية الذات المبتلاة بالجور التعسّفي، والمقصودة بالتحطيم والتهشيم نفسًا وجسدًا ووجودًا، من عمومية لفظة “الإنسان”، لتضعنا ملزمين كقرّاء أمام خصوصية التجربة المعيشة والمأساة الفريدة التي تختزنها. هذه المأساة التي يتناوب على كتمها وتغييبها إنكار النظام المرتكب لنهج التعذيب، وليس أقلّ منه -ولومن دون قصد- الصوت المعقلن والممأسس للممارسة المنظّمة و”الباردة” والمتعارف عليها لمنظّمات حقوق الإنسان.
لا تقدّم الكاتبة في أطروحتها، خطاب حقوق الإنسان ونظامه وآليات اشتغاله كمقابل نقيض لأدب السجون العربي ولا سيّما السوري منه بشكل خاص. بل هي تدعو للكفّ عن اعتماد ادّعاءات الحقيقة التي يبثّها نشاط المنظمات الحقوقية والجهات الداعمة لها، كمصدر وحيد لفضح فظاعات اقترفتها ذهنية أنظمة موغلة في بغيها وتعسّفها. فالتقارير وأشكال التوثيق الصادرة عن خطاب حقوق الإنسان، أثبتت إخفاقًا وفشلًا في الإضاءة على معاناة بالغة الظلم مُني بها أفرادٌ دفعوا أثمانًا باهظة لقاء حقّهم في الاعتراض وحرية الرأي والانتماء الفكري والسياسي. حتّى اللغة تتأرجح بين الشك واليقين، بين العجز عن تصوير عالم الجحيم المتخم برعب قادر على التمدّد والانتشار والانبعاث خارج حدود سجون دخلت التاريخ جرّاء اضطلاعها بصنوف ابتكار التنكيل. هذا الأخير الذي بقدر ما يبدو عصيًّا على الاستيعاب بسبب لامعقولية الصورة العاكسة له عبر فعل الكتابة، إلّا أنه يستبطن، هدفًا عقلانيًا مقصودًا لنفسه جراء انتهاج التعذيب الفائق للاقتصاص والعقاب من قبل السلطة التي ترمي إلى بثّ الترويع وتعميمه لتأديب عموم الشعب وضبطه، فيصير التعذيب رسالة تحذير وأمثولة.
تصادر السلطةُ هنا السلطةَ من الكتابة، وتدخلها في متاهة الارتياب من المفردات وقدرتها على الإحاطة بسيناريوهات تعذيب تمنّعت على اللغة وفاقتها. ولكن الكلمة تعاند، تصوّر، تصف، تتوالد، تقاوم، تدلّل الذات على إنسانيتها المسحوقة، تنازع لتنتزع الاعتراف من عالم خارج السجن حيث الحياة تمضي عادية محايدة. إلّا أنّ الأدب يلحّ في قرع خزّان السجون منبّهًا من هم على الضفّة الأخرى من عالم لا مبالٍ، إلى ضرورة ملامسة ألم السجين بالعاطفة والتعاطف، وبتبادل الوضعيات عن طريق تفعيل التخييل عبر اللغة الجاهدة في تصوير عالم آخر حيث الإنسان تحت مقصلة الانسحاق والإماتات اليومية؛ النفسية والجسدية البطيئة والممنهجة. وكأنّ الاعتراف الذي يطالب به فعل الكتابة الأدبية هو معاندة للاعتراف المقابل بالإدانة والإقرار التعسّفيين اللذين تجد آلة التعذيب فيهما مسوّغًا لطحن الأجساد وتهشيمها.
في الكتابة عن السجون، تتكثّف معاني الحياة وقيمها، تقول ما لم تستطع التقارير الجافة والصمّاء لحقوق الإنسان أن تقوله. لذا لا بدّ برأي طالقاني من الإنصات إلى الكتابة “فما حدث هناك، أي في السجن لم يحدث إلّا لتكتب عنه الروايات”، و”لجعل تجربة التعذيب قابلة للسرد والقراءة”. من هنا تنبثق الأعمال الأدبية التي تحرّضنا على قراءتها ومقاربتها كوثيقة حياة صاخبة تشي بوحشيّة السجّان، وانكسار السجين، والهمجية المنفلتة للسلطة في أوج جبروتها، وعار الوجود الإنساني، وسقطة التاريخ الذي لما يلبث ينتكس وينكص في البربرية التي يدّعي الخروج منها من خلال التغنّي بحقوق الإنسان.
تقصد الكاتبة إذن إلى تقديم عملٍ يقرأ نماذج في أدب السجون السوري. وتبرز أطروحتها في سياق الكتاب وتتوضّح، جاعلةً من هذا الشكل الأدبي رافدًا يضاهي في أهميته، كنوع كتابي قادر على تمثيل تجارب التعذيب والاعتقال، تقارير حقوق الإنسان، لا بل إنّ هذا النوع الأدبي يفوق الطرائق التقليدية الجافة لخطاب حقوق الإنسان المعروف. فهذا الأخير يطمس صوت المعتقل بوصفه كائنًا ذاتًا تمتلك الحقّ في السرد، سرد تجربة وجودية جماعية بقدر ما هي فردية، إلّا أنها تحكي عن جماعات من المضطهدين والمُنكّل بهم. “فالكتابة في أدب السجون هي تخليد لذكرى أولئك الذين ما يزالون يقبعون في الداخل، أو أولئك الذين لن يحالفهم الحظ بالخروج يومًا من السجن”. وكذلك فإن الكتابة عن الاعتقال السياسي هي “بالنيابة عن أولئك المحرومين من حقوق الإنسان وحقوقهم السياسية”. كما أنّ “التركيز على التجربة الجماعية للاعتقال، يذكّر بأنّ السيرة الذاتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجماعة في روايات السجون”.
ولتدعيم أطروحتها، تتشعّب قراءات شريعة طالقاني لتدخل من خلال نماذج أدبية؛ نثرية وشعرية فضاءات في مستويات عدّة تتوزّع على فصول الكتاب وأجزائه.
أدب السجون؛ صعوبة التأطير والتصنيف
في الفصل الأوّل تبحث المؤلِّفة في إشكالية التسمية والنوع أو التأطير النوعي لأدب السجون ومعايير هذا التصنيف وقواعده. ومن خلال النماذج المنتقاة وانسجامًا مع الأطروحة المركزية للكتاب تناقش الكاتبة المنحى الذي تتّخذه الرواية العربية والسورية منها بشكل خاص، بين الواقعية التجريبية ذات البعد الأيديولوجي الوظيفي ومسارات تطوّر تحرّر الرواية من الخط الواقعي نحو التخييل الملهم والمجاوز للتجريب والمستدعي للجمالية الشكلية، ومدى مقدرة كلا المنحيين التوثيقي والتخييلي على أن يضاهيا الطرق والوسائل التقليدية لآلية اشتغال حقوق الإنسان وتأثيرات الحقيقة وادّعائه لها. بل وتطرح الكاتبة إمكانية ردم العمل الأدبي لثُغر خطاب الحقوق المجحف والقاصر عن الإحاطة بالتجربة السجنيّة العميقة المعيشة للمعتقلين، والعاجز عن الولوج إلى الخصوصيات الفردية ولحظ الفروقات الثقافية في تجارب الاعتقال، والتي يقدر الأدب على تضمينها في نصوصه.
وهذا التنويع في حكايا الاعتقال وما يستتبعه من سجن واعتقال وتشويهات جسدية وندوبات نفسية، لا يعني أن التجارب الإنسانية تتمايز وتتفاضل في الوضعية الوجودية الخاصة للإنسان- المعتقل، وإنما تتضافر هذه الروايات والقصص والقصائد لتكوّن ملامح ما يمكن تسميته بأدب السجون العالمي. وتتشابه المنطقة العربية في نتاجها الأدبي في هذا المضمار، بسببٍ من تقارب الأداء السلطوي التعسّفي للأنظمة العربية ما بعد الاستعمار. وفي تطرّقها إلى المرحلة التاريخية التي رافقت ولادة أدب السجون العربية منذ المرحلة العثمانية، مرورًا بالانتداب الاستعماري وصولًا إلى الحكم السلطوي الجائر في شتّى الدول العربية، وإبرازها لكيفية بناء سيرورة أدب السجون العربية تماشيًا مع هذه المحطات وانطلاقًا منها. إلّا أن الكاتبة تُسقط أدب السجون الفلسطيني الذي يعدّ مخزونًا ثرًّا ومغذّيًا، بل ومحاكيًا لأدب السجون العربي باعتبار أن الاحتلال الصهيوني يمارس في سجونه ومعتقلاته ضدّ الفلسطينيين واللبنانيين التعذيب الوحشي نفسه الذي يلقاه سجناء الرأي العرب. صحيح أنّ عمل الكاتبة يتمحور حول أدب السجون السوري، إلّا أنها أتت على ذكر أدباء عرب مثل عبد الرحمن منيف السعودي وروايته “شرق المتوسّط”، وصنع الله ابراهيم المصري في “تلك الرائحة”، والطاهر بن جلّون الفرنسي من أصول مغربية في “تلك العتمة الباهرة”. ولا بدّ هنا من ذكر أعمال أدبية روائية وشعرية زخر بها التراث الفلسطيني والتي تحوز على هامشٍ واسعٍ من أدب السجون العربي والعالمي. ومن الشعراء الفلسطينيين الذين نظموا شعرًا في التجربة الاعتقالية والذي يُعدّ علامة فارقة في أدب السجون العربي نذكر: سميح القاسم، معين بسيسو، محمود درويش، وتوفيق زياد. وحتى المجلات الأدبية كانت من الإصدارات التي لجأ إليها المعتقلون الفلسطينيون لتسجيل يومياتهم وطرق عيشهم في السجن. ومن هذه المجلات: “الملحق الأدبي”، و”الصمود الأدبي” و”الهدف الأدبي”(1981) في معتقل عسقلان، وغيرها، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الروايات التي رافقت مراحل نضال الفلسطينيين المعتقلين ورصدت تجربتهم وسجّلتها سواء كانوا في السجن أو بعد أن تحرّروا منه. وبالتالي يندرج أدب السجون الفلسطيني من ضمن أدبَيْ السجون العالمي والعربي لأنه يتوافق مع التعريف الأشمل وغير الحاسم أو بالأصح غير المكتمل من حيث هو نوع أدبي قائم بذاته، الذي تبنّته الكاتبة لأدب السجون. وهذا التعريف هو كالآتي: “يشير تعبير “كتابات السجن” كما هو مستخدم في الإنكليزية إلى أيِّ نصٍّ، روائيًا كان أو واقعيًا، شعرًا أم نثرًا، أنتجه معتقلون في أثناء فترة سجنهم. ومن ناحية أخرى، يميل مصطلح أدب السجون إلى تضمين النصوص التي أنتجها مؤلفون معتقلون أو غير معتقلين على حدّ سواء. وتتناول تجربة السجن بإيجاز وعمق في أي شكل من أشكال الكتابة، سواء كانت على شكل مذكّرات أو سرد ذاتي أو رواية أو شعر أو قصص قصيرة أو مسرحية”.
تدلّل شريعة طالقاني إذًا على ارتباك تسمية “أدب السجون”، وتعرض مسوّغات صعوبة التصنيف وتعقيد التجربة وخصوصيتها وكون “أدب السجون لمّا يزل مصطلحًا إشكاليًا”، لالتحامه العضوي والوثيق بالواقع وبالسياسة وبالتاريخ وليس أقلَّ منها بالذات وبكينونتها وبمآزمها النفسية وبمأزق التأرجح الوجودي بين العدمية القاسية من ناحية، وإصرارها على الحضور والانبعاث من رماد القهر والإخضاع والانكسار من ناحية أخرى. هذا التذبذب بين عالمي الذات والواقع وما يتمخّض عنهما من علاقة عسيرة متمنّعة على الفهم والاستيعاب بالنسبة إلى الذات الكاتبة أو الساردة، فمن ناحية ترفض الذات المفتتة وجودها في جحيم طارد ومناف لكل تمظهرات الحياة ودلالاتها، فتنفيه، وتتعالى عليه، تواجه عدمية وجودها المضمّخ بالألم، بتفعيل فعل التخييل، وهو نوع من إعدام مقابل للواقع والتمرّد عليه. ولكن من ناحية أخرى تستمد أفعال السرد والكتابة والتصوير والتمثيل محرّضات تشكّلها وعناصر ولادتها من زمن السجن المفتوح على اللانهاية، ومكانه وأشيائه وتفاصيله، والآخر المشارك للذات في ممالك الموت، سواء الشريك في العذابات أو المرتكب لها. وكذلك أشياء المعتَقَل وجماداته وأسيجته وجدرانه ونوافذه المغلقة حتى على الهواء، وغرفه المعتمة النتنة، وآلات التعذيب المعدّة لفكرة الألم الفائق والمرعب والمهول. ومهما كان المنحى الذي يُوجّه إليه العمل الأدبي؛ توثيقيًا- واقعيًا أم جماليًا تخييليًا، فإنّ الكاتبة تسدّد نقاشها نحو أطروحتها المركزية التي تتحرّى عن كون نصوص أدب السجون وأشكاله تحتمل مقاربات أبعد من تطويقها من ضمن تصنيفات ناجزة، وخاضعة لمعايير وقواعد وأعراف محدّدة مسبقًا. فلا بدّ من استجلاء المعنى الذي ينبّه إلى “قيمة استخدام محتملة” لهذه النتاجات وهي مقدرتها على أن تطرح كمصادر موازية وأحيانًا كبدائل لتأثيرات الحقيقة المدّعاة من قبل خطاب حقوق الإنسان، “…إنّ قيمة الاستخدام المحتملة لمثل هذه النصوص المحدّدة، هي أنها تُستخدم كشهادات أو وثائق تدلّ على غياب حقوق الإنسان وانتهاكها”.
في نقد خطاب حقوق الإنسان
أوصل مسار الحداثة على الرغم من تعثّراته وفجواته، إلى ظهور “وثيقة تأسيسية لإعلان حقوق الإنسان” 1939، كثمرة لمجهود تحضيري ضخم استفاد من “إنسانيات عصر النهضة”. وفي عام 1948 تمّ تدويل هذه الوثيقة “باعتبارها مثلًا أعلى مشترك تسعى إلى بلوغه كافة الشعوب وكافة الأمم…وذلك سواء بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها، أو بين شعوب الأراضي الموضوعة تحت إشرافها”. لُحظ في المادتين السادسة والعاشرة مسألتا التعذيب والسجن، بحيث رفض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “أن يُعذّب إنسان، أو توقع عليه عقوبات قاسية غير إنسانية أو مزرية بالكرامة(المادة6). كما أنه “لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بإجراء تحكّمي”(المادة10). وعلى الرّغم من المساعي الجادّة التي رافقت تمخّض ظهور حقوق الإنسان “غير القابلة للتصرّف”، إلا أنها كيوتوبيا أخلاقية اصطدمت بعوائق سياسية تتعلّق بشكل خاص بحدود سيادة الدولة صاحبة الصلاحية المطلقة بالتصرّف كيفما تشاء، بكل ما هو موجود ضمن نطاقها الجغرافي، حتى لو كان الإنسان نفسه. فحقوق الإنسان تبقى عرضة للانتهاك من قبل سلطة الحكومات، “ولقد اتّضح أن البشر يفقدون التمتّع بحقوقهم الدنيا في اللحظة التي لا تجود بها حكومة تحكمهم، أي في غياب سلطة تحمي حقوق الإنسان، وفي غياب مؤسسة قادرة على ضمانها”. تنتفي إذًا صلاحية سريان اتفاقيات حقوق الإنسان عند حاجز الدولة- الأمة أو الدولة الوطنية أو الدولة القومية، أو أي شكل من أشكال الأنظمة ذات المنحى الأيديولوجي العقائدي، وبالطبع تلك الشمولية منها، إذ تعتبر هذه الدول أنها غير مقيّدة باتفاقيات تلزمها داخل حدودها الترابية، حتّى لو وقّعت عليها. فسوريا انضمّت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في آب 2004. وتشير الكاتبة إلى أنه ليس فقط الدولة السورية هي التي تنتهك حقوق الإنسان، “وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتّحدة وسوريا ليستا أكثر من مثالين صارخين على هذه المفارقة. إنّ اعتراف الدولة الرسمي بحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة تنفيذها أو ممارستها على أرض الواقع”. وهي تدلّ أيضًا على تفارق المنطق السيادي للدولة القومية عن الكونية المدّعاة لحقوق الإنسان، “اعتمدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية تاريخيًا على مبدأ الدولة القومية…ومع ذلك فإنّ النظر إلى الدولة بوصفها داعمة للحقوق وحامية لها، هو إشكالية متأصّلة لأنّ الدولة القومية كانت ولا تزال المصدر الأكبر لانتهاكات حقوق الإنسان”. وليست الحقوق فقط التي تضرب بها الدولة عرض الحائط، بل هي تلاحق الناشطين أيضًا وتبطش بهم، وتحلّ الجمعيات الحقوقية التي ينشطون في إطارها وبكل تعسّف تعتقل المراقبين والعاملين في مجال حقوق الإنسان. ولا يبدو أن حظ المنظمات الحقوقية خارج الدولة القمعية، بأحسن حال من الدول ذات العراقة ال ديمقراطية. وتشير حنّا أرندتHanna Arendt (1906-1975) إلى التعامل “بازدراء” كما تصفه مع نشاط جمعيات حقوق الإنسان، “والأسوأ أن كل الجمعيات التي تكوّنت انطلاقًا من الاهتمام بحقوق الإنسان…كانت مدعومة من طرف شخصيات هامشية…وكانت المجموعات التي يشكّلونها والتصريحات التي يطلقونها، تشبه في الشكل والمضمون جمعيات حماية الحيوان. ولم يتعامل مع هذه الجمعيات أي مسؤول دولة ولا أي شخصية سياسية، كما لم يعتقد أي حزب من الأحزاب الليبرالية أو الراديكالية…بتضمين ميثاق جديد عن حقوق الإنسان إلى برنامجه”. وتتّخذ مسألة تعارض الحقوق مع الدولة ومفهومها الاستنسابي للمواطنة وتطبيقاته القانونية والمدنية بعدًا آخر في بعض دول أوروبا كفرنسا مثلًا. إذًا تمثل ظاهرة التعددية الثقافية؛ الإثنية واللغوية والدينية والأقلوية، والتحيّز في التعامل مع اللاجئين والنازحين إشكالية محرجة للديمقراطيات الغربية من جهة، كما أنّ إقصاء هؤلاء الذين يتزايد عددهم من دائرة الحقوق المواطنية، يضعف من طرح حقوق الإنسان، و”يحيل على كائن إنساني مجرّد، والذي يبدو أنه لا يوجد واقعيًا في أي مكان”.
وتكمل شريعة طالقاني في استدعاء دعاوى نقدها أو لنقل ضعف ثقتها بخطاب حقوق الإنسان وعجزه عن أن ينسجم مع ماهيته وأهدافه، على الرّغم من الجهد الدؤوب والمستمر للحقوقيين والناشطين في هذا المجال، والذين تصفهم بـ “الشجعان والمصمّمين”. وفي حين تثمّن الكاتبة دأب الجمعيات الحقوقية وسعيها الشاق والمكلف ولاسيّما في سوريا والذي يعرّضها لخطر الاعتقال والسجن، إلّا أنّ نقدها لحقوق الإنسان يُلحظ في مستويين؛ الأوّل على مستوى بنية الخطاب كما يحدّده ميشال فوكو، باعتبار هذا الخطاب هو إفراز إبستيمة الحداثة كمرحلة زمنية فكرية وتاريخية خاصّة بالغرب. والثاني تقصد الكاتبة من خلاله إلى “إلقاء الضوء على بعض أشكال المحو والتشويش السردية التي قد تحدث من خلال خطاب حقوق الإنسان…”. وتلحّ الكاتبة على أنّ هذا الخطاب قد مُني “بإخفاق الاعتراف السياسي الذي ابتُلي به نظام حقوق الإنسان الدولي”. أو لنقل إن خطاب حقوق الإنسان لم يفِ بالانتظارات المرتقبة منه بخاصة فيما يخصّ المزاعم حول الاعتراف بالحقوق.
يأخذ الاعتراف بعدًا أكثر توسّعًا وتتشعّب مدلولاته في الفصل الثاني، ويكتسب مع أدب السجون بعدًا إنسانيًا خاصًّا، يتخطّى الحقوق إلى العاطفة والعطف والتعاطف وهي انفعالات وحده الأدب يستطيع أن يستثيرها. في المستوى الأوّل تلميح غير مفصّل إلى استنسابية حقوق الإنسان، وإسقاطها من قبل “أولئك القادرين على التدخّل” من دائرة اهتمامهم، بما أنها إحدى الصناعات الحداثية الكثيفة للخطابات الكثيرة والمتعددة المتناسلة من خطاب أصل ناشئ من مركزية العقل الغربي الذي هو في جوهره عقل إقصائي، طارد، انتقائي، بمعنى أنه لا يُعنى بحقوق الإنسان خارجه، أي خارج حدود الدول الغربية، وهذا ما يُفسّر الصمت المريب حيال ما يحصل في سوريا التي خذلها المجتمع الدولي المتفرّج على مأساتها المتعدِّدة الأوجه، وأحدها هو التعذيب الرهيب والإعدامات والتقتيل العشوائي للإنسان في سجونها. هذا الاصطفاء الحقوقي، أو الغربلة في المطالبة بالحقوق ومحاسبة من ينتهكها، هو ما تشير إليه شريعة طالقاني في هوامش مؤلّفها مستعيرة مصطلح “الإمبريالية الأخلاقية”. هذا الانتخاب الأخلاقي يفسّر ازدواجية المعايير التي تميّز بين نوعين من الإنسان في خطاب حقوق إنسان يدّعي كونه كوكبيًا كوسموبوليتيًا، فالإنسان الغربي المعنيّ مباشرة بحقوق تصونه وتحفظ حريته وكرامة وجوده وعيشه، هو من يمتلك حصرية التنعّم بحماية “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، في حين يُرمى بالآخر، أي من هو خارج دائرة التمركز الغربي والتنميطات الثقافية المنبثقة منه، إلى دوائر الإقصاء والاحتقار والميتات العبثية، والحروب المنفلتة والسجون حيث التعذيب وصمة عار تحرج تبجّح خطاب حقوق الإنسان.
بعد آخر في نقد شريعة طالقاني يتغيّا تبيان طبيعة خطاب حقوق الإنسان، أي بنيته وبروتوكوله ومفرداته ولغته التي يعرض من خلالها الوثائق والتقارير والشهادات المتضمّنة لانتهاكات حقوق الإنسان. وتتوضّح مقاصد الكاتبة إذا ما أُدرجت في سياق أطروحتها الأصل، أي تحليلها الذي يقارن “أدب السجون مع تقارير المتطلبات الحقوقية ووثائقها القانونية”. “فالقراءة الدقيقة لأعمال أدب السجون تشير إلى أنّ الأدب يبرز فجوات وأوجه قصور وطمس شخصيات المعتقلين، التي تعتري بيانات حقوق الإنسان وخطابه”.
يسعى النموذج التقليدي لصياغة تقارير حقوق الإنسان إلى استعمال الذات صاحبة الحق في السرد كأداة مطوّعة في الديباجة الموحّدة لأشكال مقرّرة مسبقًا. وعلى الرّغم من أنّ خطاب حقوق الإنسان ونصوص القانون الدولي يتيحان للضحية “الحق في السّرد” كمادة موثّقة للشهادة، إلّا أنّ هذه الأخيرة تخضع لضغوطات تهدف إلى “مطابقة قسرية بين الشهادة الشخصية وبروتوكولات خطاب حقوق الإنسان لاستيعابها في شكل موحّد”. يبدو أنّ هذا البروتوكول يأسر الحرية الشخصية للضحية، أو أنه لا يأبه للبعد الذاتي لسرديتها بكل ما تختزنه من تجربة فريدة، لأنها تبقى مقيّدة ضمن أطر معيارية جامدة. لذا فإنّ هذا الإلزام القسري في صوغ لغة السرد في خطاب حقوق الإنسان، لا يستجيب كما يجب لحجم المعاناة الإنسانية لأنه يملي شروط السّرد ويحدّد شكل الشهادة.
وتصير الاستعمالية أو السمة الأداتية لتقارير حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا وازنًا في خطاب حقوق الإنسان، طاغية بشكل متزايد، عندما تُغيّب الذات المعنية بالشهادة حيث يتمّ استملاك تجربتها من قبل طرف ثالث يستبعدها ويصادر سرديتها ليتكلّم بالإنابة عنها. والنائب الوكيل هنا ربّما يكون المنظّمات والمؤسسات الحقوقية نفسها. أي أنّ المؤسسة تحلّ محل الذات المبعدة والمغيّبة والمزاحة من المشهد، لتصير غائبًا بدلَ أن تكون متكلّمًا، فهي ليست إلا “مشاركًا صامتًا، وأداة أكثر منه شخصًا فاعلًا ومتكلّمًا، ومن ثم يجري تقديمه على أنه لا أحد نحويًا”. يطغى إذًا الطابع المؤسساتي الذي يقدّم الرواية وفق الأعراف الرسمية للمؤسسة أو المنظّمة التي يغلب حضورها على الذات- الضحية.
تحضر الذات إذًا شاحبة في تقارير حقوق الإنسان، يتضاءل حضورها عندما تكفّ عن أن تكون صاحبة حكاية الألم والقهر، والمالكة لحقها في أفعال الكلام والسرد والإخبار والحديث والتصريح. وفي تبعيد الضحية وتنحيتها إضعاف للاعتراف بها. يبرز الاعتراف كمفهوم تحليلي مكثّف ترتكز إليه الكاتبة لاستحضار مبرّراتها حول عدم جدارة خطاب حقوق الإنسان، وضعف تحصيناته أمام معطّلات الاعتراف بالحقوق. فما بين ضعف الاعتراف بالضحية بسبب من نمط السرد التقليدي لحقوق الإنسان من جانب، وانسداد الاعتراف السياسي من قبل الدولة القومية بحقوق الإنسان على أراضيها، تتداعى أبعاد أخرى للاعتراف، وحده أدب السجون الممتزج بمرارات الذات، قادر على إفشائها والكشف عنها.
الاعتراف بين الأدب وحقوق الإنسان
يبرز براديغمReconnaissance الاعتراف كمحط اشتغال مركزي في الفصل الثاني من الكتاب. ترسل شريعة طالقاني مقاربتها لمسألة الاعتراف ذات الطابع الإشكالي في الاتجاه الذي يصبّ عند الأطروحة المركزية، التي تبني انطلاقًا منها فصول مؤلّفها. فهي تتبنّى أدب السجون كمعطى رديفٍ وموازٍ لخطاب حقوق الإنسان من جهة ادّعائه المزعوم لإظهار حقيقة الانتهاكات جراء التعذيب في السجون السورية، وتذهب في بعض محطات معالجتها لهذه الفكرة، إلى أنّ الأدب يتحدّى ادّعاءات حقيقة حقوق الإنسان ويتجاوزها من حيث صدقية سرد التجربة وكشفها من الجوانب كافة. إحدى هذه الجوانب هي “إخفاق الاعتراف السياسي الذي ابتلي به نظام حقوق الإنسان”، “على الرغم من أنّ الاعتراف عنصر أصيل ورئيس من حقوق الإنسان في القانون الدولي، إذ يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصطلح الاعتراف على الأقل أربع مرات”. تكثر الأسباب التي تجهض مفاعيل الاعتراف في الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان وتقوّضها، وتذكر الكاتبة إحدى هذه المحبطات وهي الدولة المؤدلجة ذات المنزع التوتاليتاري المتنكّرة للاعتراف والمتلاعبة به فيفرغ من مضامينه. ارتكازًا على هذه الوضعية المثبطة لتأثيرات الاعتراف، يصير الصراع من أجله بين الناشطين الحقوقيين من جهة، والدولة من جهة أخرى مثار نزاع لانتزاعه وتكريسه ونقله إلى حيّز التنفيذ.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدلولاته ومضامينه ومراميه هو بحدّ ذاته إشهار اعتراف بحقوق الإنسان. لكنّ تشابكاته وتقاطعه مع السياسة وطبيعة المؤسسة والدولة والقانون (بخاصة أنّ القانون يشرّع لعنف الدولة، التي تحتكر العنف الشرعي بحسب ماكس فيبر)، يجعله محدودًا على المستوى الإنساني، فمعايير السياسة وضرورات القانون تطغيان على تطبيقاته وتتحكّمان في صيروراته العملية، فيصير “شكليًا صوريًا ليس إلّا، وعرضة للاستنسابية والتوظيف السلطوي، والتلاعب به من قبل النظام السياسي الذي يعترف أو لا يعترف”.
أمام هذه العورات البنيوية في خطاب حقوق الإنسان المعيقة والحائلة دون إيجاد قنوات سريان مؤديات الاعتراف على المستوى العملي بخاصة، ترتئي شريعة طالقاني الالتفات إلى أدب السجون لاستلهام دعائم تثبيت لاعترافٍ مرتبط بالمشاعر الإنسانية، كالضعف والعاطفة والتعاطف وهي تنجم عمّا تسمّيه “شاعرية الاعتراف”، فهي تقول: “إنّ أعمال أدب السجون تقدّم وتصوّر لنا شاعرية الاعتراف، التي تولّد بدورها شكلًا من أشكال التعاطف أو نوعًا من التربية العاطفية لدى القرّاء”.
إذًا على عكس الاعتراف السياسي الذي هو “أساس مفاهيم حقوق الإنسان”، تزخر نصوص الكتابات الأدبية لمعتقلي السجون السورية بمضامين تحتوي على طبقات متعددة المستويات للاعتراف تتداخل مع بنية السّرد لتشكّل تقاطعًا تلتقي عنده مسارات الرواية. فالاعتراف موجّه أساسي معلن أو مضمر، خفي أو صريح تقصده الذات أو لا تقصده لأنها لا تعرفه، ولكنّها تعيش قلقًا وجوديًا متشنّجًا جراء إنكار الاعتراف بها. يتّخذ الاعتراف هنا بعدًا ذاتيًا يرتبط بالذات نفسها، ويتمدّد ليحرّض الذات الأخرى، ذات القارئ ليخبرها عن تجربة معاناة وضعف وامتهان مقصود ومتوحّش للجسد، وإمعان في الإذلال يرمي إلى إرغام الذات المُعذّبة على التسليم بكونها “لاشيء”، فتتنكّر لإنسانيتها. وهنا يصير فعل الكتابة في المستوى الأوّل دليل وعي ومعرفة للذات بوضعيتها المأزومة، فتستعين بالكتابة لتستدلّ على هويّتها محاولة إعادة صياغتها. هنا يظهر فعل استعادة معرفة الذات للحظة وجودها المضمّخة بالألم والمعنونة بالضعف والعجز، هو الخطوة الأولى باتجاه إلحاح الذات على تصوير معاناتها وضعفها لانتزاع تعاطف القارئ ومن ثمّة اعترافه بها، وهنا “شكل من إجبار القارئ على إدراك أوجه الضعف المختلفة للشخصية” أو توليد “التعاطف” أي “الشعور بالمشاعر ذاتها التي للشخصيات” وهذا الأمر يرمي إلى المراهنة على “تحوّل آفاق توقّعات القرّاء”، ويعتمد على استعداد الجمهور المخاطب لسماع القصص، وتحمّل مسؤولية الاعتراف بالآخرين وبمطالباتهم. لكن معرفة الذات بمحنتها الوجودية العسيرة لا تسفر دائمًا عن اعتراف إيجابي بنفسها، فهذه المعرفة محفوفة أحيانًا بالمخاطر، “فلا تصل عملية ترسيخ الذات بوصفها ذاتًا تتمتّع بالكرامة الإنسانية، لكنّها ضعيفة إلى جني ثمارها الكاملة، كما أنّ القصص تنتج وعيًا عميقًا بخطورة الاعتراف الفاشل، سواء أكان ذلك ضمن سردياتها، أو لدى القارئ”. ففي مجموعة غسان الجباعي “أصابع الموز” يطيح الضعف الإنساني المتمادي بوعي المعتقل، ويتغلّب على العناصر المقاومة في الذات، فيفقد القدرة على الفصل والتمييز بين الواقع ورحلاته العقلية الخيالية والوهمية. وعندما تنتفي معرفة الذات بوضعيتها، يسقط بالتالي اعترافها بكيانها وكينونتها. فالاعتراف تابع للمعرفة.
يبرز الاعتراف “محفوفًا بالمخاطر” على مستوى آخر، ونلمس هنا إيغالًا في تعميق الاغتراب الذي يجتاح الوجود المظلم والقاسي للمعتقل. ينكر الابن أباه ولا يعرفه، ومن ثمّ لا يعترف به في القصة القصيرة بعنوان “الزيارة” المدرجة في المجموعة القصصية لـ إبراهيم صموئيل “رائحة الخطو الثقيل”. تحكي هذه القصّة عن “إخفاق الاعتراف بين أقارب الدم، بعد فترات طويلة من الاعتقال السياسي”. وتورد الكاتبة تجارب المعتقلين من ضمن روايات أخرى حيث الاعتراف الذاتي أو من قبل الآخر معدوم. تتضافر معاني الاغتراب والضعف الجسدي والنفسي، والمعاناة والألم لتكرّسها الرواية معايير لانتزاع الاعتراف، وهي هنا عناصر موازية وبديلة عن الاعتراف السياسي والقانوني الراسب في اختبار حقوق السجناء المعذّبين، والمنهزم أمام قسريات الواقع السياسي.
تلجأ شريعة طالقاني إلى بريان تورنر Bryan Turnerوجوديث بتلرJudith Butler لتفحص إمكانية توطيد الاعتراف استنادًا إلى استلهام التربية العاطفية التي يمكن للأدب أن يتيحها. فبالنسبة إلى تورنر يمكن الركون إلى الضعف والتعويل عليه كونه “حالة أنطولوجية أو ماهية مشتركة بين الجنس البشري”، “للحصول على الاعتراف بالآخر انطلاقًا من الاعتراف بضعفنا المتبادل”، والتبشير بيوتوبيا “مجتمع العاطفة العالمي”. بينما تحذّر بتلر من بساطة اللجوء إلى “بنى معيارية” ثابتة لتثبيت الاعتراف، بخاصة أن العلاقة بين الضعف والاعتراف “غير مضمونة”. فالاعتراف إلى الآن لا يأمن جانب “البنى” التي هي عرضة للتحوّلات.
بالفعل يجهد منظّرو الاعتراف لانتشاله من الرمال المتحرّكة المحيطة به. فهو مفهوم اجتماعي- سياسي وثقافي وليس ماهويًّا ثابتًا، تتداخل عناصر التحكّم في تحقيقه أو انتفائه، وتتحدّد بحسب البيئة التي يدور فيها النزاع أو الصراع لأجل الوصول إليه. توسّع الكاتبة أفق مقاربة الاعتراف، وتضيف الأدب إلى مجموع العلوم الإنسانية الجاهدة في تأسيس هذا المفهوم وتحويله إلى قيمة معيارية إنسانية. ولكن الجانب المعرفي والمفهومي على أهميته، إلّا أنه كحقوق الإنسان يحمل إمكانية أن يصير الاعتراف ذا صيغة صورية قبلية متعالية على التجارب العينية والمتحدِّدة في الشرطين الموضوعي والذاتي. وهنا يبدو الأدب بتشكّلاته كالقصص والرواية، وعلى الرّغم من توكئه على التخييل كعنصر أساس، إلّا أنه يظهر أكثر واقعية من التنظيرات التائقة إلى الترويج للاعتراف كما يجب أن يكون، بينما يصوّر أدب السجون سواء اتجه نحو المنحى الجمالي الأدبي، أو نحو التوثيق واقعًا يزخر بنقائض الاعتراف وأضداده كافة. ولكن – وعلى أهمية إدخال الأدب كرافد واقعي لتغذية الاعتراف-، هل يُعوّل على القصة والرواية والأدب بالإجمال لخلق فضاءات ترحب بالاعتراف؟ هل لحظة الاعتراف التي ينتزعها النصّ الأدبي من القارئ يمكن أن تخرج من كونها لحظة استثارة وتعاطف آنية ومتفاوتة التأثير بين قارئ وآخر، لتصير حالة عامّة ومؤثّرة على المدى الطويل؟ أليس مجال انتشار تجارب إنكار الاعتراف على أهميتها التي تحتويها روايات أدب السجون وقصصه محدودة الانتشار والتأثير؟ هل تجذير الاعتراف وتحويله إلى قناعة شائعة في حاجة إلى نوع من التربية العاطفية؟ أم إلى البحث عن سبل أخرى تصيّره ثقافة وسلوكًا مكتسبين؟ وهل سعي الأدب وغيره من النتاجات الفكرية المثمّنة لقيمة الاعتراف على المستوى الفردي والجماعي- الاجتماعي، قادرة على مجابهة سدود السلطة المتصلّبة؟
اللغة الملتبسة والزمن المرتبك وإعدام الجغرافيا؛ اضطرابات الوجود المشوّش في مملكة الموت والجنون
السلطة هي فعل اختراق لكافة المساحات؛ الخارجية منها والداخلية. وفي السجن، حيث الجغرافيا مساحة لممارسة الطغيان السلطوي المنفلت، يتفنن النظام في النفاذ إلى دواخل ذوات المسجونين لتعبث بالنفس كما بالجسد، فتحفر توقيعها مستعملة شتّى صنوف العذابات وفق إيقاع ممنهج وهادف إلى إلحاق التشويه النفسي والتسبب بالخلل العقلي، تمامًا كما تعيث تنكيلًا فظيعًا بالأجساد. أمام هذا “الجنون الهندسي المرعب” يمعن الفكر السلطوي في استملاك الزمان بتفاصيله كافة، والمكان بكل محتوياته وتفصيلاته، فيحضر النظام السلطوي بكلّيته المطلقة التي تربي الألم وتسقيه ليتعاظم فيصير فكرة طاغية الحضور، كذلك فكرة الرعب، الخوف، الجنون… ينتبه السجين إلى أنّ معضلة وجوده تتقلّص أمام استفحال وحش الأفكار. يحاول أن يستردّ بعضًا من مساحة يتحايل فيها على هول الفكرة بفكرة أخرى يبتدع من خلالها زمنيته الخاصة، ويبتكر مفاهيمه التي يراوغ من خلالها قسوة المكان ليصيّره أليفًا ووطنًا. وتبقى اللغة ملاذه الذي لا يأمن جانبه دائمًا. فانتظاراته منها في مساندته وحفظ تجربته ونقلها، تبقى محفوفة بمحاذير التعثّر، والخيانة والعجز. في الفصول؛ الثالث والرابع والخامس تتوغّل الكاتبة في الأماكن القصيّة التي تلامس غور التجربة السجنيّة في جوانبها الأكثر التصاقًا بمأساة السجناء. الزمن الثقيل الوطأة، وحتمية المكان، ومعاندة تسرّب اللغة والفشل في تطويعها وتجهيزها لتصير قادرة على أن تحيط بحجم الألم والعذاب الذي يبدو لوهلة أنه عصيّ على السّرد.
تتساءل الذات التي لا تصدق لامعقولية التعذيب: “أيمكنك أن تكون أمينًا لواجبك، بضرورة عرض كامل التجربة، من أوّل الجلجلة حتّى آخر الجحيم؟”. تشكّك الذات المعذّبة في احتمالية انتصار اللغة في مواجهتها للوجع الفائق. التعذيب يدمّر الكلام، يشلّ اللغة. في غمرة الألم العارم يتقوقع السجين على جسده فيقتصر عالمه على أوجاعه، ينعزل عن العالم الخارجي، فتقصيه “المعاناة عن الدلائل الأولى للإنسان (العقل والكلام) وبالتالي تُدمّر ذات الفرد”. السلطة تقهر اللغة. ولكنّ السجين من جانب آخر يحاول أن يلملم ذاته المفتّتة بسياط الألم، والمبعثرة بتيه المفردات، من خلال اللغة نفسها. فبحسب الكاتبة إنّ “تصوير التعذيب في الأعمال الأدبية يقدّم أساليب بديلة للتصوير، مقابلة لأطر القياسات المعيارية لخطاب القانون الدولي لحقوق الإنسان”. تبقى الكاتبة إذًا في مربع رهانها الأصل وهو تقديم أدب السجون كصيغة مكمّلة أو معادلة ضرورية لخطاب حقوق الإنسان. الجمود نفسه يطيح بممكنات اللغة على المستوى الوصفي وليس العاطفي فقط، السجون المبنية على الدم والتي تفوح منها رائحة الموت العبثي. تدمر السجن-الأسطورة، “مملكة الموت والجنون” كما يسمّيه فرج بيرقدار، و”السجن المطلق” بحسب ياسين الحاج صالح. تدمر حيث البذخ في التعذيب، يضع السجين أمام معضلة لغوية لأن صور الموت والتنكيل واللاحياة فيه غير قابلة للوصف، أو السرد. وما بين وجوم الصمت وخيانات اللغة يبرز “التشكيك في قدرة اللغة ومحدوديتها في تصوير العنف الذي تعرّض له معتقلو تدمر”. حتّى في الشعر حيث فسح التخييل تتيح لمخيّلة الشاعر أن تنطلق، تتلعثم اللغة، لأنّ الصور الآتية من جحيم تدمر “تتجاوز القدرة الوصفية للشاعر، وتبيّن التوتر بين الحاجة إلى الإخبار وإثبات الصدقية والشهادة…”.
يجد سجن تدمر أشباهه من السجون في بانوبتيكون Panopticon العصور الوسطى، حيث تتضاءل الهندسة المعمارية المكانية، وتطفو السلطة في التقنية الحاذقة للرقابة والضبط وإحصاء أنفاس السجناء، وتحديد مجالهم البصري، فيمنع على السجين إجالة بصره إلّا في حدود ضيّقة، فيصير حبيسًا داخل الحبس “يُمنع السجناء من إجالة النظر في اتجاهات معيّنة، لأنّ النظر أو الرؤية لهما أهمية حاسمة في محاولة السجين خلق مساحة داخل بيئة السجن”. يمثّل السجن مساحة مادية ساكنة وإلزامية، وهويوازي ربّما العالم السفلي. وعلى الرّغم من زحف السلطة وعتوّها اللامتناهي، وظلّها الثقيل الطاغي والطافح في جراحات الجسد، وظلام النفوس والمسبب لانعطابات اللغة، إلّا أنّ السجناء يتجرّؤون على رسم خرائط مضادة لما هو مفروض في مملكة الموت.
تتضارب هنا الاعتبارات لدى السجناء حيال زمنية السجن وخصوصية مكانه. هبة الدبّاغ التي ابتلعت الدقائق الخمس المزعومة عمرها، ترى في السجن “موتًا بطيئًا” “فالتمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل يصير أكثر صعوبة”. والتكيّف هو فرض الضرورة وخيار الأمر الواقع للبقاء في قيد الحياة. بينما يذهب ياسين الحاج صالح إلى اللامفر منه، وهو محاصرة حصاره. السجن بكل سرياليته يمكن أن ينقلب إلى “شكل من أشكال الحياة”. تشكّل ابتكارات السجناء نوعًا من “جغرافيا عاطفية” مكافحة ومقاومة لجغرافيا السلطة في السجن. فالكتابة عن أدب السجون تبيّن كيف أنّ المعتقلين “يظهرون سلوكًا مضادًا في مواجهة الأنظمة التأديبية للسجن، ويرسمون التجارب العاطفية لشراء الوقت وترويضه، ويوثّقون ابتكار الأنماط الحياتية والتصالح والمقاومة داخل السجن”. الوقت في السجن عبء ثقيل، وعيشه عمل شاق. يبتدع السجناء أفكارهم لالتقاط الزمن المار والجاري بلامبالاة قاسية، يحاولون شراءه وترويضه من خلال مفهوم “الاستحباس”، وهو “عملية التأقلم والاستقرار في السجن، أو التصالح والاستسلام”. والاستحباس يؤول إلى شكل أو نمط تآلفي وتصالحي مع مكان السجن وزمانه، فيكفّ الوقت عن أن يكون محض عدوّ. المقاومة هنا هي التحايل على مادية السجن وواقعيّته الصارخة، فيقلّ التركيز على مساحات السجن الموضوعية ووظيفته كمساحة للاعتقال والتعذيب وهدر الحياة، ويُوجد السجناء وسائلهم الخاصة للهروب الذهني والعاطفي والروحي والفكري. وفي حين يحاول السجّانان الأكبر والأصغر، أي النظام وجهازه السجني الذي يقتات وينتعش من أفكار الرعب والإخافة والألم والقتل، أن يُعدما الوجود المكاني والزماني المُعتَقلين، يلتفّ هؤلاء على محاولة إماتتهم المدروسة والمتقنة، ويلجؤون إلى ما نجحوا حتّى الآن في حفظه والنجاة به إلى حدّ ما ربّما من استشراء أفاعيل السلطة والسجن، وهو ملكات العقل والخيال والعاطفة ومسارح الذهن حيث يلوذون، فينسجون زمنًا ومكانًا آخرين، وكأنّهم في هذه المساحة المختلقة يواجهون إعدامهم بإعدام مضاد للسجن بالإشاحة عن واقعيته الشاهقة والدامغة. تمنح قدرة المقاومة السجين هامشًا لخلق جغرافيّته الخاصّة، تجيش فيه انفعالات الضعف ويتأرجح بين الاستسلام والتصدّي، تخذله اللغة، تنحسر الكلمات، ينكمش الكلام، يتبخّر المكان المباشر للسجن، تفيض المخيّلة بأمكنة أخرى، الزمن يُروّض، يُستعاد بطريقة ما، الهروب متاح على الرّغم من القيود والأسيجة والجدر العازلة للحياة. فهل يمكن لتقارير حقوق الإنسان أن تحيط بمدى هذه التجارب؟ هل هي قادرة على اتباع توصيف يصوّر الجغرافيا المنسوجة في ذهن السجين والطالعة من انعجان بألم وقهر لا يمكن احتمالهما؟ تذكّر الكاتبة أنّ شهادات حقوق الإنسان وتقاريره قاصرة عن لحظ فرادة التجربة السجنيّة، فهي “تطمس ومن دون قصد وتستثني أصوات المعتقلين وتجارب الاعتقال التي عايشوها، ولاسيّما أساليب الحياة والتصالح والمقاومة وشراء الوقت. وقد يؤدّي ذلك إلى إخماد صوت سجين الرأي بوصفه مواطنًا قادرًا على الحديث، أو إلى إسكات الأفراد الذين يعيشون أوضاع الاعتقال من دون قصد”.
وكما أنّ خطاب حقوق الإنسان غير قادر على الإحاطة بفرادة التجربة السجنيّة والغوص إلى أعماقها، فإنه وفي مستوى آخر لا يستطيع “نقل تجارب الصّوت ووظائفيّته، سواء كان عاملًا وسيطًا للتعذيب النفسي والضغط على المعتقلين من قبل السلطة، أو كان قدرة صوتية تخلق مساحات من الجغرافيا العاطفية. فتقارير حقوق الإنسان تُعنى فقط بجغرافيا السجن الموضعية المتعيّنة، بينما الأدب وحده يستطيع توصيف تجربة الصوت والمشاهد الصوتية، ويضفي الطابع الدرامي على التجربة المكانية”. يُزجُّ بالصوت في هندسة الرعب المتكاملة للسجن، تُقيّد المساحة المرئية الضيّقة أصلًا، تشخص عينا المُعتقل في اتجاه محدود وتنحسر الرؤية وينقبض مجالها. إلّا أنّ الأذنين تلتقطان أصوات التأوّه والتألّم، وتستنفر الحواس لتلقي صراخات الألم وربّما حشرجات الموت. تغدق استراتيجية السجن الشيطانية على السجناء بسلسلة من الصور الصوتية المروّعة فيصيرون “شاهدي سماع” لا “شاهدي عيان”، “وتحوّل السلطة الصوت إلى شكل من أشكال التعذيب لزيادة معاناة السجين، بخاصة خلال فترة التعذيب حيث لا يمكن للمعتقلين الهروب من البيئة الصوتية للسجن”. ولكن في المقابل، فلإرادة المسجونين صولة مع التوظيف السلطوي للصوت وتطويعه في الجهاز الرعبي المتضلّع في فنون التعذيب. فعلى الرغم من أنّهم محاطين ببيئة “مصممة للحرمان الحسّي”، فإن السجناء يبتكرون وسائل تواصل مختلفة، “بما في ذلك الهمس عبر الثقوب في جدر زنزانات السجن، وابتكار نظام للطرْق على الجدر يسمح لهم بمعرفة الأخبار ونشرها”. تظهر هذه الطرق المبتكرة أنّ الصوت يمكن أن يُفلت من الرقابة العالية الضبط للسلطات، وتشير إلى كيفية خلق المعتقلين “لفضاءات من العزاء”، لتخفيف رهبة الزنزانة حيث لا يسود شيء آخر سوى الظلام وظلّ الرعب المخيّم على الأذهان والنفوس.
الكتابة عن السجن والمنفى بين السرد وما وراءه
في الفصل السادس من الكتاب، يدخل المنفى كعنصر من تنامي إشكالية السّرد. فكما السجن، يختزن المنفى تجارب فردية تلحّ هي الأخرى في توثيقها والكتابة عنها، “فالسجن والنفي وجهان لتجربة الاضطهاد. وأدب السجون يمكن أن يُفهم ومن نواحٍ عدّة على أنه أدب المنفى”. وهما “وسيلتان للعقاب في شكل من أشكال الإبعاد ونزع الألفة والاغتراب”. فالسجين السياسي والمتهم وجهان لعملة الاتهام والإبعاد والطرد من المجال الوطني والاجتماعي. فالشخص المنفي “الذي يُقصى من مجتمع مغلق، يجد نفسه مقصيًّا من عائلة الأمم كلّها”…”والخسارة الثانية التي تكبّدها من لا حقوق لهم هي عدم حمايتهم من طرف حكومة، وهو الوضع الذي لا تترتّب عنه خسارة الوضع القانوني في بلدهم الأصلي فقط، ولكنّهم يفقدون هذا الوضع القانوني في جميع البلدان”.
ينتصب في السياق المتنامي لعمل الكاتبة، ثالوث الكتابة والسجن والمنفى. ولا يبدو أنّ الكتابة السردية تخلد إلى شكل واضح وناجز ونهائي من السرد المرتبك بتعقيدات تجارب فردية وجماعية مضطربة، تصخب بمعاني الألم والذل والقهر والموت والاغتراب والضعف والجنون وقلق الهويّة المسحوقة والتائهة واللامعترف بها والمقصية من دوائر الاعتراف الذاتية الجسدية والنفسية والاجتماعية-الحقوقية والجمعية على أشكالها. عند نقطة عجز الكتابة عن تبليغ تشنجات هذه التجارب الأليمة وتصوير تعقيداتها، تأخذ الكتابة عنها منحى آخر هو ما وراء السّرد. فكما السجن، كذلك يضعنا المنفى أمام رؤى تعددية التجربة التي تلحّ على صاحبها بكتابتها. وتنبّه الكاتبة مستعيرة من إدوارد سعيد من تمجيد المنفى والاحتفاء به. ومع كونه عنصرّا ثريًا وقويًا من عناصر الثقافة الحديثة، إلا أنّ المنفى هو السجن والسجن هو المنفى، وكلاهما شرطان حيويان للكتابة.
ما وراء السرد هو المنبّه النقدي لفعل الكتابة، والفاحص لأساليب البناء وللبنيات الأساسية للرواية السردية. وفيما وراء السرد يتموضع الكاتب في موقع غامض، ويصير “متطفًلا على النص، بوصفه راويًا يعكس ذاته”. في الكتابة الماوراء-سردية لا يُرى الكاتب في النص، بل يبقى على حدوده، إنها نوع من الكتابة التخومية أو لنقل المحايدة حيث يكون وجود الكاتب مواربًا ونصفيًا ومحتجبًا. والهدف من هذا النوع الكتابي هو “زيادة وعي القارئ بشروط بناء المعنى في السرد”. وبذلك يحقق ما وراء السرد وظيفته، وينتج مساره الخاص للنقد الذاتي. انطلاقًا من الهامش النقدي لما وراء السرد، تنجح الكتابة في أن تمسك دفتيّ الخيال والواقع دون أن يكون أحد الطرفين مغبونًا أو مطموسًا. فلا يطغى الخيال على تجربة الاعتقال الحيّة. “فالوظيفة النقدية لما وراء السرد كخطاب حدودي بين النقد والخيال، مع الإبقاء على الوضوح في الحتمية السردية التي تُعدّ أساسية لبناء مزاعم الحقيقة في خطاب حقوق الإنسان”.
خلاصة
لا تُسقط شريعة طالقاني من نطاق أدب السجون، الأفلام الموثّقة أو المصوّرة لتجارب المسجونين السوريين في سوريا. فهي تتطرّق إلى فيلم منصور العمري “82 اسم: سوريا، نرجوكم لا تنسونا”، وأفلام أبو نضارة، التي تهدف إلى توثيق وحفظ وتخليد ونقل المعاناة الظالمة والبائسة للمعتقلين انطلاقًا من الحق في الصورة الذي هو في الأهمية نفسها للحق في السرد. وهي تُثري كتابها ببانوراما واسعة من أسماء الرواة والمؤلّفين، وعناوين الروايات والقصص حيث التجربة رواية حيّة، تدور أحداثها في صلب الحياة وليس على هامشها أو في حواشيها، وإنّما هي الوجه المظلم والمعتم لهذا الكون المليء بالإجحاف والذي يلفظ بشاعته ويرميها سرديات منبوذة. لكن الكتابة على الرّغم من المخاطر المحيقة والشرانق التي تهدِّدها بالاختناق والخرس، يجب أن تكون قناديل الضوء التي تدلّ العالم إلى أماكن السواد. الكتابة هي المتنفس لذات اختبرت وحشية الظلم الذي لمّا يزل يبتلع حيوات ليس الأفراد فقط، وإنما مجتمعات القهر والبؤس والاستبداد والتعسّف ليتذكّروا أنهم لا يزالون فيقيد الحياة، إنها بشكل أو بآخر محاولة إعادة تجميع هوية الذات المتكسّرة بأقسى سياط الإذلال والجور. وحتى التفات مدّعي الكون إلى ما يحصل في أقبية السجون السورية والفلسطينية، وأي سجن أو مكان في العالم تسفك فيه كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، تبقى حقوق الإنسان ادّعاءً وتبجّحًا ومزاعم لا أكثر.






