صادق جلال العظم
ترجمة هويدا الشوفي
المصدر:
Is Islam Secularizable? Challenging Political and Religious Taboos
ISBN: 978-3-940924-26-1 (hardcover)
ISBN: 978-3-940924-27-8 (eBook)
First published 2014
by Gerlach Press, Berlin, Page 201.
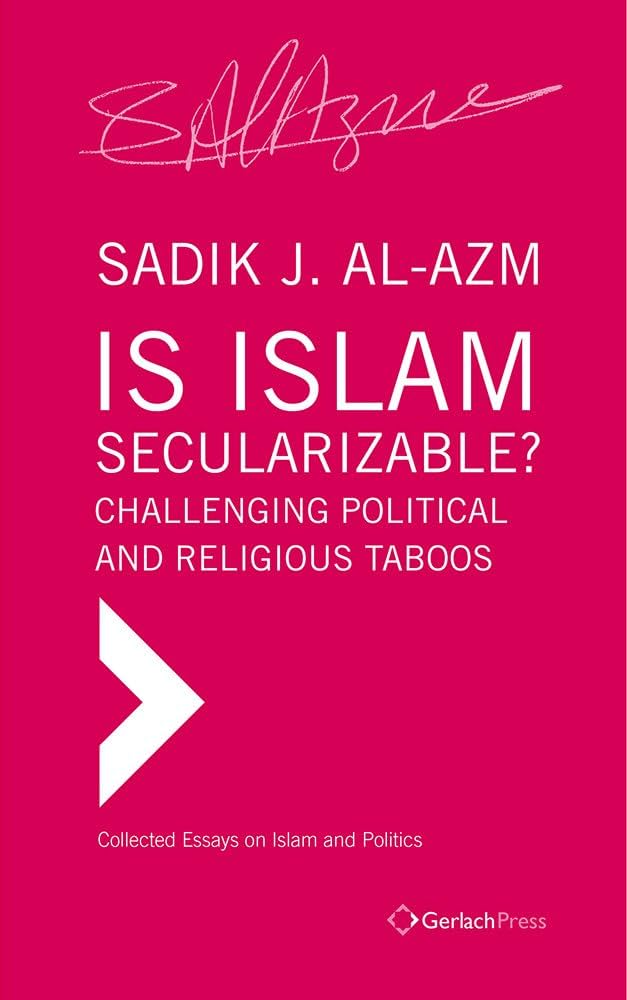
آمل من خلال مناقشتي هذه لمسألة المجتمع المدني العربي والربيع العربي أن أتمكن من تسليط بعض الضوء على طبيعة الثورات التي ضربت فجأة عددًا من الدول العربية الرئيسة -بعد فترة طويلة من الركود والانحدار- وتسليط الضوء كذلك على الخلفية التاريخية الحديثة والسياق الاجتماعي لما أصبح يُعرف بالربيع العربي.
اشتدت الجلبة حول “المجتمع المدني” و”الحكومة المدنية” وأكّدت على آنيتهما وأهميتهما في منتصف سبعينيات القرن الماضي -خاصة في مصر وسورية ولبنان، مع مساهمات مهمة من مفكري شمال أفريقيا ومثقفيه؛ والمثال الأشهر على ذلك هو “النقاش” وتبادل الرسائل الذي دار حول موضوع العلمانية في العالم العربي بين مفكّرَين عربيّيْن ومثقّفيْن بارزين، أحدهما في المغرب العربي والآخر في مصر.
منذ ارتباط مفهوم “العلمانية” في اللغة العربية بالإلحاد ومعاداة رجال الدين، اكتسب مصطلح “مدنية” الهيمنة بوصفه تعبيرًا ملطفًا للعلمانية، ولشكل علماني للحكومة، ولنوع معتدل من فصل الدولة وسياسات السلطة والقانون من ناحية، عن الإسلام كعقيدة ودين من ناحية أخرى.
في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وخاصة بعد حرب تشرين أول من عام 1973، بين إسرائيل من جانب ومصر وسورية من جانب آخر، أصبح من الواضح أن الإجماع السياسي الثقافي العربي السابق على القومية والشعبوية والاشتراكية العربية، التي جمعها معًا وترأّسها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قد انهار بشكل كارثي وتلاشى.
بطبيعة الحال، اندفعت أشكال متعددة من الإسلام والإسلاموية والجهادية لملء الفراغ السياسي والثقافي الناتج. فقد بدا في ذلك الوقت أن الفاعلين الناشطين الوحيدين في المجتمعات العربية الرئيسة، خاصة في مصر وسورية، هم كلٌّ من الأنظمة العسكرية مع أحكامها العرفية وحالة الحصار من جانب، والإسلام المتمرد المسلح مع مطالبه بالتطبيق المباشر لقانون الشريعة (الأحكام العرفية للإسلاميين) وشعاره القوي، آنذاك، “الإسلام هو الحل” من جانب آخر. وعند هذا المنعطف الحرج، فرضت مفاهيم “المجتمع المدني” وممارساته و”الحكومة المدنية” نفسها بوصفها السبيل العملي الوحيد للخروج من ذلك المأزق المدمّر. كان هذا هو الظرف الذي تكثّفت فيه مخاوف العرب ونقاشاتهم حول “المجتمع المدني” و”الحكومة المدنية” وكان يُعتقد بأنها مسألة أكثر أهمية وإلحاحًا من أجل تجنّب سيناريوهات حالة أسوأ.
إذًا، اتخذ التعريف العملي “للمجتمع المدني” شكل نفييْن اثنين: فهو مجتمع مواطنين متساوين لا يقوده ولا تديره سلطات الأحكام العرفية ولا إسلاميو قانون الشريعة على غرار إيران.
وذُكر التعريف العملي للحكومة المدنية في ذلك الوقت على أنه: حكومة محايدة إيجابيًا إزاء الأديان والطوائف والمذاهب والانتماءات العرقية التي تتشكل منها شعوب بلدان مثل العراق وسورية ولبنان مثلًا.
في ظل المخاوف العربية حول هذه القضايا، فإن مفهوم “المجتمع المدني” ليس مجرد فئة توصيفية فحسب، بل هو بالنسبة لنا، وخاصة في الوقت الراهن، محتوى نقدي وحداثة سياسية. لهذا السبب يحتل جون لوك John Locke وهيغل Hegel وماركس Marx وأنطونيو غرامشي Antonio Gramsciمكانة بارزة في هذه المناقشات ويتم الاستشهاد بهم مرارًا وتكرارًا كنقاط مرجعية محورية من أجل التحقق والإقناع.
يمكنني القول إنه، وبحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، انبثق شبه توافق جديد يتعلق بكيفية الخروج من المأزق الذي تم التوصل إليه بين استبداد الدولة العسكرية من جهة، والعنف العشوائي للمعارضة الإسلامية والجهادية من جهة ثانية. لقد تبنّى شبه التوافق هذا فكرة “المجتمع المدني” بالإضافة إلى عدد من القيم والممارسات الحليفة التي تواكبها عادة مثل سيادة العلاقة المدنية، وبعض الاحترام لحقوق الإنسان، وشيء من القضاء المستقل، وموقف أكثر اهتمامًا بأمور مثل الحقوق والحريات المدنية.
ازدهر هذا التوافق الجديد لأول مرة سياسيًا وعمليًا في ربيع دمشق قصير الأمد بين عامي 2000 و2002، وفي الوثائق المهمة التي أنتجها ونشرها، وفي حركة المجتمع المدني التي أشعلها، وفي إعلانه “ميثاق 99” (الذي سُمّي على اسم المبادرة المدنية الشهيرة في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية المعروفة بميثاق 77، 1976-1992). وكلها شكّلت نوعًا من التمهيد والتدريب النهائي لاندلاع الربيع العربي اللاحق وتطلعاته وقيمه ومطالبه وشعاراته.
هناك تمييز أساسي رسمته حركة المجتمع المدني تَمثّل في وضع “المجتمع المدني” في المقدمة و”المجتمع الأهلي” أدنى منه. تميّز المجتمع الأهلي بسيادة العلاقات البدائية وأشكال من التنظيم الاجتماعي مثل النسب وروابط الدم والقبيلة والعشيرة والانتماء العرقي والمذهب الديني وغيرها، ولكل منها “عصبيته”. يأتي مفهوم عصبية من ابن خلدون ويُترجم عادة ب “تضامن جماعي”. لكن، في الواقع، مصطلح “عصبية” ضعيف جدًا لأجل غاياتنا هنا، لأنه يفشل في إيصال تهمتي التعصب والتعنت القويتين اللتين يجب إضافتهما إلى مفهوم “التضامن” الانجليزي قبل مقاربة مفهوم “العصبية” العربي.
تاريخيًا، انبثقت المجتمعات المدنية العربية من المجتمع الأهلي ببطء وتميل إلى أن تطفو فوقه. وكان الفاعل الرئيس لهذا الانبثاق هو الدولة الاستعمارية وما بعد الاستعمارية الحديثة، مع التشريعات والقوانين الحديثة التي تعمل كقوى فعالة للتغيير والتحديث السوسيو اقتصادي. وكما هو ملاحظ تمامًا، تميل الروابط البدائية في المجتمع المدني إلى التآكل والتخفف لصالح نُهجٍ وأشكالٍ لتفاعلٍ اجتماعيٍّ أكثرَ نفعيةً.
أنا أذكر كل هذا لأن الإخوان المسلمين والإسلاميين في العالم العربي يتعمدون التعتيم على هذا التمييز عبر التحدث والتصرف كما لو أن المجتمع المدني هو المجتمع كله، خاصة في أماكن مثل مصر وسورية. بالتالي يُغرقون عمدًا أي مجتمع مدني موجود الآن بالمقدمة في أعماق بحر المجتمع الأهلي السفلي، لأن المجتمع الأهلي هو النطاق السياسي للإسلام والإسلاميين، حيث تكمن فيه بالفعل قاعدتهم الشعبية ومصادر قوتهم. لهذا السبب يتحدثون بصوت عالٍ ويقبلون بحزم الديمقراطية كحكم الأكثرية لكنهم يلتزمون الصمت التام حيال كون الديمقراطية حقوقًا للأقليات. بهذا المعنى، قد يُنظر إلى “العودة إلى الإسلام” على أنه رد المجتمع الأهلي على هذا الشيء الذي نسميه المجتمع المدني العربي ومستجداته عبر منظمات وأدوات مثل جماعة الإخوان المسلمين وأخواتها وفروعها.
يُعتبر ذكر كلمة مدني بالذات، بالنسبة إلى الأنظمة العرفية العربية، لعنةً، فحيث تُذكر كلمةُ “مدني” فإن أول ارتباط يتبادر إلى الذهن العربي هو: “ليس عسكريًا”. لقد عملت هذه الأنظمة بشكل مقصود على تفتيت أي مجتمع مدني قد نكون حققناه في بلدان مثل العراق وسورية، وتفتيته على غرار التقسيمات البدائية للمجتمع الأهلي عن طريق تنشيط “العصبيات” الكامنة في تلك التقسيمات. كل هذا من أجل جعل أي نوع من المعارضة المنظمة الشعبية أمرًا محالًا. لهذا السبب تم سحق ربيع دمشق وحركة المجتمع المدني بسرعة كبيرة وبوحشية. في النهاية، يستخدم كلٌّ من الحكم العسكري وحكم الشريعة الإسلامية الإساءة ويستغلون المجتمع المحلي من أجل غاياتهم ومصالحهم الخاصة، وهم يقومون بذلك دومًا على حساب ظهور المجتمع المدني وبطرق مسيئة للمجتمع المدني.
واسمحوا لي أن أضيف هنا أن التفكير في المجتمع المدني العربي من حيث كونه طريقة للخروج من مأزق دولة الأحكام العرفية التي تتصدى للمعارضة العنيفة التي تعتمد على قوانين الشريعة الإسلامية، وبوصفه وسيطًا مستقلًا ومجالًا محايدًا نسبيًا بين المجتمع الأهلي وانشقاقاته وعصبياته من جهة، والدولة العسكرية من جهة أخرى… هذا التفكير يشبه طريقة تفكير المنظرين والفلاسفة الأوروبيين، في وقت مضى، في المجتمع المدني بوصفه مجالًا للنشاط والتفاعل والعلاقات البشرية، هذا المجال ليس من اختصاص الأسرة الخاصة التقليدية ولا من اختصاص الدولة الحديثة التي تتزايد وظائفها العامة. فقد حدّد هيغل هذا المجال الجديد بـ “المجتمع البرجوازي”. بينما فهمه دوركايم Durkheim من حيث إنه تقسيم جديد للشغل بين المجال العام للدولة بذاته والمجال الخاص للعائلة كذلك، وهو متعلق بالترتيب الجديد بالكامل بوصفه مميزًا لأوروبا الحديثة. كان غرامشي يعتقد أن المجتمع المدني النابض بالحياة هو الحماية الأفضل والضمان ضد استيلاء العناصر والقوى الأكثر رجعية في المجتمع على السلطة.
ينصبّ التركيز في المناقشات الغربية الحالية على المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية والكنائس والمساجد والنوادي والجمعيات الخيرية ومجموعات المساعدة الذاتية والروابط المهنية والنقابات العمالية ومجموعات المصالح المختلفة وما إلى ذلك، وكلها عناصر حاسمة في معنى المجتمع المدني. يعطي أوغسطس نورتون Augustus R. Norton من جامعة بوسطن Boston University في عمله حول المجتمع المدني في الشرق الأوسط التعريف التالي للمجتمع المدني:
المجتمع المدني هو توليفة من المنظمات المستقلة والهيئات والنقابات ومجموعات المصالح والنوادي والمؤسسات الاجتماعية والأحزاب السياسية التي توفر حاجزًا بين الفرد وسلطة الدولة.
هذا التعريف ساكن جدًا ومدروس للغاية بحيث لا يعطي وصفًا دقيقًا للمجتمعات المدنية التي ما زالت قيد التشكيل في العالم العربي. فالعديد من العناصر المذكورة في تعريف نورتون تميل إلى أن تكون جزءًا من المجتمع الأهلي أكثر من كونها جزءًا من المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، يتجاهل تعريف نورتون تمامًا المحتوى النقدي في استخدامنا لمفهوم المجتمع المدني ويخفف حداثته السياسية. يذهب عالم الأنثروبولوجيا بجامعة دارتموث Dartmouth University ديل إيكلمان Del Eickelman، بارتكازه على هذا النوع من الفهم للمجتمع المدني، بعيدًا جدًا في حماسه لإثبات (ضد المتشككين الغربيين أمثال إرنست جيلنر Ernest Gellner) أن المجتمع المدني موجود فعلًا في بلدان الشرق الأوسط. ويذهب إيكلمان إلى حد التأكيد على أنه وُجد في العراق وإيران، في ظل الدولة البُويْهِيَّة Buyid dynasty في القرنين العاشر والحادي عشر، مجتمعات مدنية نابضة بالحياة وتعمل. وبالنسبة له كذلك، يعادل المجتمع المدني وجود المؤسسات المستقلة عن الدولة التي تحافظ على علاقات اقتصادية وسياسية منظّمة اعتمادًا على أشكال من الارتباط غير الرسمي وما إلى ذلك.
إن حمل مفهوم المجتمع المدني كما نفهمه ونروّج له اليوم والذي يعود إلى الشكل الذي وُجدت عليه مجتمعات العراق وإيران إبان القرنين العاشر والحادي عشر هو إساءة سافرة للمصطلح، مما يجعل فكرة المجتمع المدني تافهة تمامًا بالنسبة إلى الغايات العربية الراهنة. كانت التقسيمات الكبرى للمجتمع الإسلامي التقليدي هي الأحرار مقابل العبيد، والمسلم مقابل غير المسلم والرجل مقابل المرأة وطبقة العامة مقابل الأرستقراطيين. هل من المنطقي الحديث عن “المجتمع المدني” في ظل هيمنة مثل هذه التقسيمات والتصنيفات الاجتماعية القديمة؟ مرة أخرى، إذا وُصفت مجتمعات العراق وإيران إبان القرنين العاشر والحادي عشر بشكل جدي على أنها “مجتمعات مدنية”، فما هو المثير والجديد إذًا، حيال هذا الشيء الذي ندعوه بالمجتمع المدني في العالم العربي؟ لماذا كل هذه الجلبة؟ ولماذا البلبلة؟ ربما بقينا، كذلك، حيث كنا في القرن العاشر كعرب وإيرانيين. أضف إلى ذلك تلك الدلالة الضمنية بأن تاريخنا غير قادر على إنتاج أي شيء جديد حقًا في هذا الصدد والذي هو ليس مجرد استمرار لما كان في مرحلة تاريخية كلاسيكية معينة أو فترة زمنية ما. هنا، يُظهر نورتون وإيكلمان نفسيهما بوصفهما سلفيين جيدين في رغبتهما في تبرير الحاضر عن طريق الاستناد إلى الاستمرارية مع الماضي السحيق والدعوة إلى دعم الأسبقية المفترضة لما كان لدينا وما نحن عليه اليوم.
بصفتي عربيًا، أفهم أنه من الطبيعي “في المجتمعات الغربية شديدة التشتت” التفكيرُ في المجتمع المدني من حيث ميل المنظمات غير الحكومية والنوادي والكنائس والمساجد والجمعيات التطوعية بأشكالها كافة إلى جمع الذرات الاجتماعية المنفصلة وتعزيز الشعور بالمجتمع المحلي. لكن هذه ليست مشكلة كبيرة على الإطلاق في المجتمعات العربية والشرق أوسطية. على سبيل المثال، فإن الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر أهمية لتعزيز المجتمع المدني في العالم العربي هو فكرة “المواطنة” وممارستها والتي تتخذ شكل انتقال من سنّي إلى مواطن ومن أقلية عرقية إلى مواطن ومن علوي ودرزي وإسماعيلي إلى مواطن ومن المرأة بوصفها عورة في المجتمع المحلي إلى امرأة بوصفها مواطنة متساوية مع الرجل في المجتمع المدني. كل هذا غائب في تعريف نورتون للمجتمع المدني، في حين يصبح من السخافة تمامًا إرجاع هذا العتاد إلى مجتمعات العراق وإيران في القرن العاشر، كما يفعل إيكلمان.
بكلمات أخرى، من الأفضل الإقرار منذ البداية بأن النضال من أجل مجتمع مدني فاعل في العالم العربي هو ليس استعادة لشيء ما كان موجودًا في الماضي ولا امتدادًا له، لكنه تأسيسٌ لأمر ما جديد حقًا حيث، مثلًا، يتم تحويل طبقات التجار القديمة والأنماط البازارية من المجتمع الأهلي إلى شيء يشبه البرجوازية الحديثة.
اسمحوا لي أن أشير، من أجل غايات التباين والمقارنة، إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين أو الجماعة (كما يصرّون على تسمية أنفسهم) قد رسّخوا أنفسهم عمدًا وعن سابق إصرار، في بداية تشكّلهم أواخر عشرينيات القرن الماضي، في هويات ما قبل المدنيّة وقبل المواطنة للشعب المصري. وتستمر هذا الممارسة حتى وقتنا الراهن.
واسمحوا لي أن أشير كذلك إلى أنه مع نهاية الحرب الباردة، أصبح الجزء الأكبر من اليسار العربي -بمن فيهم معظم الأحزاب الشيوعية-من أكثر المدافعين حماسة وفصاحة عن المجتمع المدني ودوره ونوع البرامج والممارسات المصاحبة للفكرة. لم تكن هذه خطوة انتهازية بحتة من قبل شريحة كبيرة من اليسار، لكنها كانت انحسارًا إلى خط الدفاع الثاني ضد ما كان يراه اليسار على أنه القرون الوسطى الزاحفة للإسلاميين والجهاديين وطالبان من جهة، واستبداد دول الأحكام العرفية التي عشنا في ظلها من جهة أخرى.
أستطيع القول الآن: إن الربيع العربي كان، وهو في أوج نشاطه، أفضل فترة للمجتمعات المدنية العربية الشبابية من تونس إلى القاهرة إلى صنعاء إلى بنغازي إلى المنامة ولكن لا ينطبق الأمر نفسه على دمشق حيث أثبتت تجربة ميدان التحرير استحالتها. وفوق هذا، هزمت جماهير ميدان التحرير المبدأ السلالي المتمثل في تمرير الرؤساء العرب السلطة إلى ذريتهم وضمنت، من حيث المبدأ، انتصار الفكرة الديمقراطية للتداول الانتخابي للسلطة، وكل ذلك يتلخص في صيحات “لا تمديد، لا تجديد، لا توريث” التي دوّت في جميع أنحاء ميادين التحرير في العالم العربي والتي ترجمت بحرية مقولات:
“لا” كبيرة للتمديد الميكانيكي لفترة حكم الرئيس، و”لا” كبيرة أخرى للتجديد التلقائي لولاية أخرى للرئيس، وهناك “لا” أكبر لرغبة الرؤساء المتعذرة السيطرة عليها في تمرير السلطة إلى أبنائهم أو أقربائهم. بكلمات أخرى، فلتسقط جمهورية أبناء العمومة في العالم العربي. في هذه الميادين، وجدت أخيرًا العديد من المجتمعات المدنية العربية صوتها، وهي منشغلة بتأكيده.
لقد غابت بشكل واضح عن الربيع العربي وميادين تحريره وقواه الثورية النداءاتُ التقليدية للقومية العربية القديمة الطيبة وشعاراتها ومطالبها وراياتها، خاصة كما عهدناها خلال أوجها في أوائل الحقبة ما بعد الاستعمار من القرن الماضي وما بعده.
لذا، مثلما لم تُرفع لافتات في أي مكان من تونس إلى القاهرة إلى طرابلس إلى صنعاء إلى حمص في سورية تقول إن “الإسلام هو الحل”، كذلك لم تظهر في الأفق لافتات تقول إن “الوحدة العربية هي الحل” أو “العروبة هي الحل”.
كانت كل صيحات ميدان التحرير ونداءاته ومطالبه وشعاراته وأهدافه تمثّل قِيم المجتمع المدني وتطلعاته النموذجية، وتمحورت كلها حول الحرية والحقوق والكرامة والنزاهة والديمقراطية والشفافية والمساواة وما إلى ذلك. أستطيع القول هنا: إن كل هذا تم إعداده بعناية فائقة وبصورة منهجية وطُرح وقُدّم في الملفات التي أنتجها ربيع دمشق وحركة المجتمع المدني الخاص فيه.
والأهم من ذلك أن تجارب ميدان التحرير أظهرت كيف تحولت كاريزما اللحظة الثورية، لأول مرة على الإطلاق، من التركيز العربي المعتاد على زعيم واحد وفذّ إلى تدفق وانتشار الجماهير المحتشدة في ميادين التحرير العديدة، ما جعل الجموع المحتشدة هي اللحظة الكاريزمية الحقيقية للثورة والتغيير.
في الواقع، كانت لحظة كاريزمية لتأكيد الذات الجمعية وقول الحقيقة للسلطة، بغض النظر عن المخاطر والتهديدات المصاحبة لمثل هذه الخطوة.
هذا التطور المهم أمر جديد علينا نحن العرب وعلى تاريخنا الاجتماعي والسياسي الحديث. إنه المساهمة الأساسية للمجتمع المدني حتى اللحظة. وهكذا، فقد تميزت ميادين التحرير في تونس والقاهرة وصنعاء وبنغازي بالمشاركة الهائلة للنساء والحضور اللافت للأطفال والفتية والفتيات؛ هذا، في مجتمعات محافظة للغاية ومدن محتشمة جدًا.
أضف إلى ذلك أشكالًا متنوعة من الفن، وأنماطَ التعبير المبتكرة، والموسيقى، وعروض الأداء، والأغاني، والمسرحيات، والرقصات، والبالونات، والصلوات، والرسوم الكرتونية الساخرة، والتعليقات اللاذعة، والرسومات النقدية على الجدران. كان يتم كل ذلك، عمومًا، بوجوه مريحة، رغم استخدام البلطجية الشرسين والميليشيات الفتاكة والقمع العشوائي والذخيرة الحية بالجملة. في الواقع، كان هناك روح وممارسة كرنفالية في كل هذه الميادين المزدحمة، بالمعنى الباختيني[1] للكرنفال الذي يسخر من ادعاءات السلطة العليا والقمع ويفرغها من معناها. ومن المؤكد أن كل هذا لم يُسمع به من قبل في تاريخ الاحتجاجات السياسية العربية الحديثة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الكياسة والتسامح كانا في ذروتهما بشكل غير طبيعي في ميادين التحرير هذه. سأذكر مثالًا: في حين كانت مصر معروفة لفترة من الزمن بالنزاعات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وحالات القتل وحرب الكنائس وما إلى ذلك، فإن ميدان التحرير في القاهرة كان على العكس تمامًا طوال العشرين يومًا التي استغرقتها إطاحة الرئيس مبارك. خلال هذه اللحظة الكاريزمية، يمكنك رؤية الكهنة المسيحيين بلباسهم المميز وقبعاتهم وصلبانهم يؤدون الشعائر الدينية القبطية، بينما تجد إلى جانبهم إمامًا يقود صفوف المسلمين في الصلاة بدون أي أثر للتوتر أو التدخل. بشكل مشابه، تشتهر القاهرة المزدحمة بالتحرش بالنساء، إلا أنه لوحظ عدم تسجيل أي حالة تحرش جنسي ولم يتم تقديم أي شكوى طوال فترة تجربة ميدان التحرير هناك.
المثير للاهتمام هو أن ثورات الربيع العربي لم ترفع رايات “الشرعية الثورية” لتبرير نفسها أو تلجأ إلى “العدالة الثورية” للتعامل مع خصومها على غرار ما جرى في إيران عند نجاح ثورتها الإسلامية. بل لجأت، بدلًا من ذلك، إلى مفاهيم المجتمع المدني النموذجية مثل “الشرعية الدستورية” و”إجراءات العدالة الواجبة” الاعتيادية للتعامل مع خصومها. وهذا الأمر يُعد قطيعة كبيرة مع تاريخ الانقلابات العسكرية التي عرّفت نفسها بـ “ثورات” وبررت استيلاءها على السلطة عن طريق اللجوء إلى “الشرعية الثورية” وتعاملت مع خصومها من خلال المحاكم الخاصة والإجراءات القضائية الزائدة.
في سورية، أثبتت تجربة ميدان التحرير استحالتها بسبب وحشية القمع العسكري. مع ذلك، اُتهمت الثورة هناك بأنها عفوية وبلا قيادة وتفتقر إلى الاستراتيجية. وذلك لأن اللحظة الكاريزمية للثورة شهدت هنا مرة أخرى تحولًا من القيادات القديمة لأحزاب الطليعة المنظمة والقادة المنفردين الملهمين والشخصيات البطولية الاستثنائية الفذة إلى لجان التنسيق المحلية الشبابية المعروفة باسم تنسيقيات. إن لجان التنسيق المحلية هذه هي التي قادت قوى الشارع في الثورة ونشّطتها، وهي المسؤولة عن الحفاظ على الجانب المدني وغير العنيف إجمالًا من الانتفاضة ضد الحكم العسكري والأحكام العرفية والدولة البوليسية التي كانت عليها سورية طوال نصف القرن الماضي. بالنظر إلى عفوية هذه اللجان، فقد تمكنت من ربط نفسها بشبكة وطنية تتواصل باستمرار مع نشطاء مشابهين في سورية والعالم العربي بالإضافة إلى العالم الواسع خارجها، باستخدام الخبرة العظيمة لآخر ما توصّل إليه العلم من أشكال الاتصال الإلكترونية لتعزيز أجندتهم الثورية. لقد تمكنوا كذلك من إحباط جهود النظام العسكري لحجب تدفق المعلومات وقمعها، وذلك عبر الحفاظ على تدفق ثابت لصور البث المباشر والمعلومات الحيوية حول ما كان يجري فعلًا على الأرض في جميع أنحاء سورية وعلى مدار الساعة عمليًا.
على الجانب العسكري، أجبرت الفصائل المحلية المقاتلة إلى جانب لجان التنسيق، من خلال انتشارها الكبير في جميع أنحاء سورية، قوات النظام على الانتشار بشكل ضئيل في جميع أنحاء البلاد في نفس اللحظة، مما أدى إلى تشتيتها وإنهاكها واضطرارها إلى التحرك المفاجئ جيئة وذهابًا من درعا في أقصى الجنوب إلى الحدود التركية في الشمال ثم العودة من جديد إلى وسط وجنوب البلاد. لهذا السبب نسمع أن مدينة ريفية مثل درعا قد غزتها هذه القوات واحتلتها ثم أخلتها عشرين مرة على الأقل خلال أقل من خمسة عشر شهرًا.
أما بالنسبة إلى الجيش السوري الحر، فأود أن أذكّر الجميع هنا بأنه أُثيرت في أوروبا والولايات المتحدة، خلال النصف الثاني من القرن الماضي، الكثير من التساؤلات على المستوى الوجداني حول مسألة ما إذا كانت الأوامر العليا -خاصة الأوامر العليا العسكرية- تُعفي أولئك المأمورين من المسؤولية تجاه أفعالهم. لقد التزم المنشقون عن الجيش السوري (ليشكلوا الجيش السوري الحر) بعفوية وبدون الكثير من التفكير بالمعيار الذي يقول إن الأوامر العليا المتعلقة بارتكاب الجرائم والفظائع لا تُعفي المأمورين بأي شكل من الأشكال من مسؤوليتهم تجاه تصرفاتهم وأعمالهم. إنهم يرقون إلى مستوى ذلك من خلال رفضهم الأوامر العليا بإطلاق النار وقصف قرى تشبه قراهم وناس مثل أهلهم وأحياء تشبه أحياءهم. هذا هو المعنى الأخلاقي لانشقاقهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم وأقربائهم لخطر بالغ برفضهم الانصياع لهذا النوع من الأوامر العليا. علينا أن نشكر نجومنا، كسوريين، ذلك لأن الجيش السوري ما زال جيشًا إلزاميًا وشعبيًا وليس جيشًا مهنيًا. وأنا أكنّ بالغ الاحترام لهؤلاء الضباط والجنود وهم يستحقون تقديرًا واحترامًا أكبر من الأوروبيين والغربيين بشكل عام.
مع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن روح تجارب ميدان التحرير وكاريزميتها لم تمت بالتأكيد في كل من تونس ومصر ما بعد الثورة، لكنها تواصل النضال ضد الصعاب الكبيرة من أجل صنع مستقبل أفضل لهذه البلدان. في الواقع، ولو أصبحت عشرون أو ثلاثون في المئة فحسب من روح الثورة وكاريزميتها روتينًا في الحياة العادية لهذه المجتمعات، لكان قد تم تحقيق تقدم كبير بلا شك.
يجب أن يكون هذا واضحًا من حقيقة أنه عندما طالب الرئيس المصري المنتخب حديثًا، والذي نفذ صبره من الإجراءات العملية الواجبة الفوضوية المرافقة للمرحلة الانتقالية الديمقراطية نحو الاستقرار والحياة الطبيعية، بسلطات وصلاحيات مطلقة لنفسه، الأمر الذي يعني وضعه هو ورئاسته خارج أي مساءلة، انفجر نصف الشعب المصري فجأة غضبًا واحتجاجًا ضد أي تلميح إلى احتمال إعادة إنتاج الاستبداد التقليدي المصري والرؤساء المستبدين. من هنا يظهر، في هذه العملية، أن مصر اليوم ليست مجرد إخوان مسلمين وسلفيين وأصوليين ومتعصبين دينيين لكنها كذلك مجتمع مدني ناشط يتبلور.
كان ثوران المجتمع المدني كثيفًا ومنتشرًا لدرجة أن الرئيس مرسي اضطر سريعًا إلى سحب هذا المرسوم الاستبدادي والدفع باتجاه آخر لضمان أن يتم تمرير مسودته الخلافية للدستور لُيصادق عليها في الاستفتاء. على الرغم من الخطاب الإسلامي الثقيل والمبررات الشرعية، لم يشارك سوى جزء بسيط من الناخبين في الاستفتاء، وصادق على مسودة الدستور هامش غير مهم إلى حد ما، بينما القاهرة ردت ـ”لا” مدوية على الدستور. بكلمات أخرى، ولأول مرة على الإطلاق يُحرم حاكم مصري من تفويضه بقيادة البلاد وإدارتها على النحو الذي يراه ملائمًا. من المؤكد أنه تطور مزلزل في السياسات العربية السلطوية السابقة والحالية والسياسات العربية الشعبوية. مرة أخرى، لقد كانت أفضل أوقات المجتمع المدني.
سأختتم كلامي ببعض الملاحظات التوضيحية الإضافية حول الربيع العربي والثورة في سورية:
الربيع العربي يعني ببساطة عودة السياسة إلى الناس وعودة الناس إلى السياسة بعد قطيعة طويلة للغاية بسبب الاستيلاء المديد على السياسة واحتكارها في البلدان العربية الأساسية من قبل زمر صغيرة من النخب العسكرية وأزلامهم، خاصة أزلامهم من رجال الأعمال.
في سورية، الربيع العربي هو المحاولة الشعبية لاستعادة الجمهورية من السلالة المتوارثة العسكرية المغتصبة التي أعلنت نفسها “إلى الأبد” والتي تطبق شعارها “الأسد أو نحرق البلد”. أصبحت الآن سياسة حرب الأرض المحروقة التي ينتهجها الأسد معروضة في كل مكان حول العالم.
القصد هنا هو وضع حد نهائي وإلى الأبد لـ “سورية الأسد” والانتقال ببساطة نحو “الجمهورية السورية” بدون تعديلات و/أو توصيفات إضافية.
على صعيد آخر، يتعامل النظام الدولي في الوقت الحاضر مع سورية بالدرجة الأولى من حيث الجغرافية السياسية الكبرى والاستراتيجية العالية ونزاعات القوى الكبرى على المصالح الحيوية وما إلى ذلك، بدون اهتمام كبير بالمصادر الداخلية وديناميكيات الثورة نفسها، وهو أمر أحاول التأكيد عليه. وهذا النهج واضح جدًا في وسائل الإعلام الغربية كذلك. هناك شريحة من اليسار (عربية ودولية) وقعت تحت تأثير إحدى صِيغ هذا النهج من خلال رؤية دسيسة أو مؤامرة إمبريالية غربية عالمية ضد النظام الوحيد في المنطقة الذي ما يزال يقف في مواجهة إسرائيل وما يزال يشكل حجر عثرة في طريق الامبريالية نحو الهيمنة الشاملة على الشرق الأوسط وبلدانه وموارده.
بهذه الطريقة، لا يُنظر إلى سورية وثورة شعبها إلا على أنهما مجرد بيادق في هذه اللعبة الكبرى للدول، في حين أن واقع القمع طويل الأمد والمتصاعد يتم تجاهله في أحسن الأحوال وفي أسوأ الأحوال يتم رفضه بوصفه غير ذي صلة.
على سبيل المثال، عندما رسم الرئيس أوباما علانية وبصراحة الخط الأحمر لاستخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، نُظر إلى الأمر في سورية والعالم العربي في العموم على أنه طريقة ساخرة للغاية تقول للأسد: يمكنك مواصلة قتلهم بكل ما لديك من وسائل، ما عدا الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، عندما اُستخدمت فعلًا الأسلحة الكيميائية، عدّل أوباما خطه الأحمر ليعني: “الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للأسلحة الكيميائية” وليس مجرد استخدام الأسلحة الكيميائية فحسب.
بشكل مشابه، عبّرت التعاملات والنقاشات الدولية حول سورية عن قلق حيال الأقليات في البلد وحقوقهم (الأكراد والمسيحيين والعلويين والدروز والإسماعليين والتركمان والشركس وغيرهم). يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الأغلبية السنية في البلاد لضربة وحشية من قوات النظام والميليشيات وصواريخ سكود التابعة لأقلية عسكرية صغيرة تحتكر بشكل مطلق السلطة وثروات البلاد. الآن، كل القرى والبلدات والمدن والأحياء السكنية التي قُصفت وهُدمت وغالبًا ما تم تسويتها بالأرض هي ذات أغلبية عربية سنية. بينما ظلت مجتمعات الأقليات وقراهم وبلداتهم ومدنهم آمنة تقريبًا ولم تُمس نسبيًا حتى هذه اللحظة. لقد قُتل 100000 أو نحو ذلك حتى الآن من الأغلبية المطلقة، وأيضًا الجرحى والمصابون بإعاقة دائمة والمختفون والمغيبون والمسجونون والمعذبون هم في الغالب من الأغلبية العربية السنية. والملايين من السوريين الذين أصبحوا لاجئين داخليين وخارجيين، والمنفيين و/أو النازحين هم كذلك من الأغلبية السنية. لذا، ما يُداس بالأقدام في سورية حتى الآن، في هذه اللعبة الكبرى المفترضة بين الدول، هم الأغلبية نفسها وحقوقها، والتي يبدو أن لا أحد يتحدث عنها خارج سورية. أضف إلى ذلك الافتراض الصامت -لكنه خاطئ- بأن السنّة تنتظر اللحظة المناسبة لتهاجم الأقليات وتضطهدها وتقمعها. في ظل هذه الظروف، تحتاج سورية كلها الآن الحقوق والحماية والاهتمام والانتباه وليس أقلياتها فحسب.
في الواقع، يعيدني النقاش الدولي حول الأقليات السورية وحماية حقوقها، في وقت تواجه فيه الأغلبية السنية هجومًا همجيًا وتتعرض لقمع وحشي، إلى أوروبا القرن التاسع عشر وإلى ما كان يُدعى آنذاك بـ “المسألة” الشرقية” مع دبلوماسيتها الحربية الشهيرة، حيث كانت كل قوة أوروبية جديرة بقوتها، لذا كانت تبحث عن أقلية في منطقتنا من العالم لتتبناها وتحميها. فرنسا، تولت الكاثوليك الرومانيين المحليين والعلويين. روسيا، تولت الأرثوذكس الإغريقيين المحليين. بريطانيا، تولت الأنجليكان والبروتستانت القلائل إلى جانب الأقلية الدرزية وهلم جرا.
لن أبالغ إن قلت إن الأجهزة الأمنية العسكرية في سورية (المخابرات المخيفة) نظرت إلى نفسها على أنها كتلة جرانيتية لا تُقهر حيث ينهار كل ما يصطدم بها ويتحول إلى غبار بسرعة هائلة. لقد شهد كل المثقفين المعتقلين وسجناء الرأي السوريين بعد إطلاق سراحهم، بأنه بعد اعتقالهم كان يقدم إليهم ضباط التحقيق والتعذيب النصيحة الأخيرة التالية “لماذا تزعجون أنفسكم بالنقد والمعارضة والاحتجاج، مع أنكم تعرفون بأننا كتلة صلبة لا تُقهر ذات إرادة فولاذية تحطم أي شيء وأي أحد يقف في طريقها. اذهبوا وابحثوا عن شيء أكثر نفعًا للقيام به بدلًا من الانخراط في هذا النوع من السياسة والمعارضة العقيمتين”.
أهم إنجاز حققته الثورة السورية إلى الآن، بتقديمها تضحيات كثيرة، هو تحويلها لهذه الكتلة الجرانيتية المتغطرسة وقليلة الحياء والوحشية إلى ظل لذاتها وشبح لما كانت تعتقد أنها عليه هي وسلطاتها التي لا تُقهر، وتحويلها لما كانت تتخيل هذه الكتلة أنها عليه وما كانت تريد من الآخرين أن يتخيلوه عنها إلى أمر تافه. لهذا السبب اضطر الأسد إلى استدعاء ميليشيات حزب الله من لبنان والمنظمات الشيعية شبه العسكرية من العراق وإيران لدعم موقفه المتدهور وقبضته الضعيفة على البلاد. ولهذا السبب أيضًا لم تتمكن قواته وحزب الله والميليشيات الأخرى المقاتلة من احتلال مدينة ريفية صغيرة مثل القصير قرب حمص إلّا بعد فترة حصار طويلة، على الرغم من أعدادهم الهائلة ووفرة القدرة القتالية.
لا أقصد هنا الاستخفاف بنمو التطرف ومخاطره على سورية ومستقبلها، خاصة التطرف الديني، بل التأكيد على أن التطرف، سواء أكان دينيًا أو غيره، هو ليس شأنًا أحادي الجانب في الوضع السوري.
بالطبع، كلما طال تشبث الأسد ودولته البوليسية بالسلطة واستمر باستخدام طياراته الميغ وسيخوي وصواريخه الباليستية وسكود ضد سكان سورية ومدنها وقراها ومزارعها وغاباتها، كلما، تعاظم خطر نمو التطرف من كل الأنواع، والتي يعد التطرف الديني أقلها خطرًا. لأنه، في مجتمعاتنا وفي لحظات الأهوال العظيمة والمخاطر الشديدة والأزمات، يلجأ الناس إلى الله. وهذا بدوره يجلب العزاء والمواساة من ناحية، ويجلب الانتقام المقدس والجهادية المقاتلة والانتحارية المستميتة من ناحية أخرى. الإسلام المتشدد الذي تعيشه الثورة السورية الآن، يشجع إلى أبعد الحدود تجنيد الإسلاميين والإخوان المسلمين والجهاديين وطالبان والتفجيريين الانتحاريين بين الشباب السوري. تعني الخطابات حول الحاجة إلى الاستقرار والاستمرارية في سورية ما بعد الأسد ببساطة قطع رأس النظام القاتل، عن طريق إزالة بشار، مع ترك الدولة البوليسية الإجرامية على حالها دون مساس.
ما زلنا نسمع طوال الوقت عن مدى خطورة الوضع وتعقيده وحساسيته ودقته. لكن، إذًا، ما هو الخطير والمعقد والحساس والدقيق جدًا حيال النظام الأقلوي المسلح للغاية والوحشي الذي تديره وتدعمه طائفة أقلوية صغيرة تستخدم كل الأسلحة الحربية الثقيلة الحديثة والمتاحة لسحق ثورة أغلبية البلد؟
لهذا السبب، كذلك، من غير الصحيح ولا الدقيق وصف ما يجري في سورية على أنه حرب أهلية. ففي الحرب الأهلية المعممة في لبنان، هاجمت الجماعات والطوائف والفصائل وأجزاء من البلد بعضها بعضًا وتقاتلت فيما بينها بشراسة كبيرة بينما وقفت الدولة عاجزة بلا حول ولا قوة. أما في سورية، وبخلاف نموذج لبنان، فالدروز ليسوا بصدد مهاجمة جيرانهم السنة في حوران، ولا السنة يحضّرون لغزو الأراضي الإسماعيلية ولا الإسماعليون يجهزون أنفسهم لتسوية حسابات قديمة بالعنف مع جماعة العلويين وهلم جرا.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من حقيقة أن ضحايا المجازر العديدة التي ارتُكبت في مختلف أنحاء سورية كانوا كلهم سنة، إلّا أنه لم يتم الإبلاغ عن هجمات انتقامية ضخمة قامت بها قرى و/أو جنود السنة، على الرغم من أنه معروف جيدًا أن العديد من القتلة أتوا من بعض تلك القرى العلوية.
يكاد يكون التطرف منسوبًا دومًا إلى المعارضة ومرتبطًا بها، لكنه نادرًا ما يُربط أو يُنسب هو وشروره إلى النظام وقواته والميليشيات الغازية، على الرغم من وضوحه.
مهما كان التطرف الذي تنتجه الثورة، فإنه يكاد يكون لا شيء أمام تطرف النظام وكتلة سلطته التي تمطر الناس بالغازات السامة والأسلحة الكيماوية.






